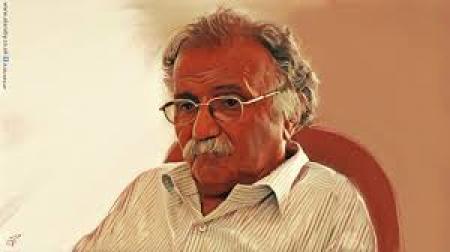بقلم/ دكتور محيي الدين عميمور
لم تكن استقالة الطيب بلعيز من رئاسة المجلس الدستوري أمرا مفاجئا، وأراها خطوة جديد بالتقدير لأنها تساهم، ولو جزئيا، في نزع فتيل الأزمة، وإن كانت التعليقات على الاستقالة وتبعاتها من بعض عباقرة التحليلات الاستراتيجية، الذي ابتلينا بهم عندنا مع كثرة قنوات التلفزة، أصبحت صورة لما يُطلق عليه تصرفات “الرويبضة”.
أحدهم تحدث عن “كمال فنيش” بوصفه الرئيس المؤقت للمجلس، من منطلق أن من عيّنه ليس رئيس “الجمهورية” وإنما رئيس “الدولة”، ولو قرأ “الرويبضة” المتعالم المادة 104 من الدستور لفهم أن تعيين رئيس المجلس الدستوري لا يدخل في إطار المحظورات بالنسبة لرئيس الدولة (وليس رئيس الدولة المؤقت كما يخلط البعض بين الوضع في مرحلة الـ45 يوما والوضع في مرحلة الأشهر الثلاثة.)
وأنا أتصور أن الدستور، وبرغم كل ما يمكن أن يُنسب له من عوار، يضم المواد الكافية التي يُمكن، بالقراءة السياسية السليمة لها، أن تعطي الحلول الملائمة للمشاكل القائمة حاليا، الحقيقية منها والمفتعلة، وإن كان هذا يسدّ الباب في وجه كل المتلهفين على مجلس رئاسي “لا دستوري” يعطيهم فرصة التموقع في مراكز قيادية .
والتصريحات الخاطئة قد لا تنطلق دائما من سوء نية، ولعلها ناتجة عن رغبة مواطن طيب بعث السرور في نفوس أبنائه وهم يرونه متحدثا في التلفزة كأي مسؤول كبير، ولكن تصحيح بعض التصريحات ضرورة ماسة خلال الأوضاع الحرجة التي يمكن أن يجتازها بلد ما، والتي تنتج عن “وجود” عناصر شعبوية هامشية يجرفها معه تيار “التسوماني” الشعبي العظيم، وسواء كان الوجود مجرد تفاعل ذاتي متحمس أو محاولات مقصودة لتضخيم عدد المتظاهرين (وهو ليس في حاجة لأي تضخيم مفتعل) أو لتسريب شعارات معينة بهدف تزوير الأهداف الرئيسية للانتفاضة الشعبية.
وكنت قلت إن الاستقالة المتعجلة للرئيس وضعتنا في مأزق لم تكن له أي ضرورة، لكن التركيز الرهيب من اتجاهات معينة على تنحية مسؤولين معينين يثير التساؤل لأنه ارتبط بمواقف فجة معارِضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي يحدده الدستور، كان منها موقف من قالوا إنهم يمثلون نادي القضاة الأحرار، وبأنهم لن يراقبوا الانتخابات، “وهذا قرار نهائي”، وهو تأكيد قيل بخفة لم أعهدها في القضاة، فالقرار المُتخذ هو قرار سياسي، وليس هناك قرار سياسي لا نهائي، لأن هذه القرارات تخضع لتطورات الأحداث ولاختلاف المعطيات، هذا إذا تجاهلنا أن تسييس قضاة لموقفهم عمل خطير يمس بمصداقية ونزاهة السلطة القضائية.
واطمأنت نفسي عندما قال لي العارفون بأن رأي القضاة يُعبر عنه المجلس الأعلى للقضاء، وأن النادي المذكور هو تجمع مُبتدع لم يحصل بعدُ على أي اعتراف بشرعيته، لا من مجموع القضاة ولا من الهيئة المعنية بتقنين الجمعيات والنوادي وغيرها.
وبالأمس أعلنت قناة تلفزة خاصة بسعادة واضحة عن قرار نحو خمسين رئيس بلدية بمقاطعة عملية الاستعداد للانتخابات، وبرغم أن العدد هزيل مقارنة بأكثر من 1540 بلدية في الجزائر فقد لوحظ انتماء هذه البلديات لمنطقة واحدة تقريبا، ينتسب رؤساء بلدياتها لحزب محسوب على التيار اللائكي، وهو ما أعطى للموقف لونا جهويا خاصا، رأيته أمرا بالغ الخطورة، ذكرني بعام 1963.
وعندما أربط هذه المعطيات مع بعضها لا أستطيع دائما تغليب حسن النوايا أو منطقية المطالب، فالمطالبة بتنحية مسؤولين “عملوا في إطار نظام الرئيس المستقيل” تعني مئات المسؤولين (وليس الموظفين) منهم ولاة ورؤساء دوائر ومدراء بنوك ورؤساء شركات وطنية بالإضافة إلى البرلمانيين، ومع ملاحظة أن البعض ينسون أو يتناسون أمناء المنظمات الجماهيرية الذين التصقوا بمقاعد المسؤولية منذ أكثر من عشرين سنة، حتى راح البعض يتساءل عمّا إذا لم يكن في نية بعضهم توريث المنظمة لأحد الأنجال أو الكريمات.
لكن لا بد من الاعتراف أن الفساد لا يمكن أن يستشري إلا إذا كان الرأس فاسدا، وأذكر تعبيرا قاله يوما الرئيس الراحل هواري بو مدين من أن المجاهد الجزائري خلال الثورة كان ينقل على كتفه كيسا مليئا بالأوراق المالية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، بدون أن تنقص منه ورقة واحدة مهما كانت ضآلة قيمتها، لأنه كان يسترشد بقدوة الرجال.
لكن، إذا كان الرقص شيمة أهل البيت إذا كان ربّ الدار بالدف ضاربا، فكيف يمكن أن يكون الحال إذا كان ربّ الدار مُغيبا بمرض عضال أو ببطانة سيئة.
لكن أخطر ما في الأمر هو ما تردد على الأفواه من تغوّل رأس المال المكتسب عن غير الطرق الشرعية، والذي راح يمنح بعض المسؤولين رشاوى مالية مباشرة، أو بشراء سيارة للبُنية أو إهداء شقة للابن أو استكمال بناء فيللا تعثر بناؤها لأسباب مالية.
وعرفت التجارة مظاهر فساد غريب كان وراءه أحيانا بعض من يعظون الناس ويوصونهم بتقوى الله، وأصبحنا نعرف ارتفاع سعر موادٍ استهلاكية ينخفض سعرها في العالم كله، ونستورد البنان (الموز) من أمريكا الجنوبية، ولكن عن طريق فرنسا بالذات، في حين أن البنان في إفريقيا ألذ طعما وأرخص ثمنا وأكثر فائدة في ربط العلاقات الاقتصادية مع العمق الإفريقي.
وغرقت البلاد بمصنوعات مزورة برعت فيها الصين، التي أصبحت مدرسة في الفساد والإفساد.
وأصبحت الأرض مشبعة بالمواد سريعة الالتهاب بحكم ما كان المواطن يتابعه بحسرة العاجز عن إيقاف عملية التدهور المتزايد في المعاملات وفي الأخلاقيات وفي ظروف الحياة، برغم طفرة هائلة في الإنجازات العمرانية والبناءات الجامعية والبنى التحتية وفي التخلص من الديون الخارجية، وكلها إنجازات لا ينكرها إلا جاحد أو لئيم.
لكن كل ما أنجز بدا بلا لون ولا طعم ولا رائحة عند من يعيش في ظلام اليأس فاقدا حاستي الذوق والشم نتيجة لعملية التصحر السياسي والاجتماعي التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة، والتي تتحمل السلطة السياسية، حكومة ومعارضة، مسؤوليتها الأولى.
لقد تحولنا، أكاد أقول جميعا، إلى قنوات هضمية وقوارض استهلاكية وظواهر صوتية، في ظل اختفاء مشروع قومي يستنفر الحماس ويستقطب التجنيد ويملأ الأجواء بعبارات التفاؤل التي تنتظر أياما أكثر سعادة، وراح البعض يسخر من شعار “من أجل حياة أفضل” الذي كان يمثل الضوء في آخر النفق، وراحت الألسنة “المتسايسة” تجترّ وتلوك عبارة “برنامج الرئيس” لتجعل منها نشيدا وطنيا يعزف في كل مناسبة، وغالبا بدون مناسبة.
وحتى الجامع الأعظم الذي أريد منه أن يكون مفخرة للجزائر، أسيئ التخطيط له معماريا، فأصبح بناؤه مثار سخط عند كثيرين، لا يترددون في القول إنهم كانوا يفضلون أن يبنى بدلا منه مستشفًى كبير يوفر على مسؤولينا الانتقال إلى باريس أو غير باريس.
وهكذا انطلق الحراك الشعبي في 22 فبراير، وأشعلت جذوته فكرة العهدة الخامسة، والتي قلت عنها موجها كلامي، بكل أدب واحترام، للرئيس : “إذا كان هو قرارك فهو خطأ، وإذا كان “قرارهم” فهو خطيئة”، لكن صوتي كان أضعف من أن يخترق هتافات المريدين ليصل إلى مكتب المرادية.
وكان التساؤل: أين مؤسسة الأمن الهائلة التي كانت أذرعها موجودة في كل المستويات من قمة الدولة إلى أصغر بلدية في أبعد ولاية، بل كان مجرد ذكر اسمها يثير الذعر في نفوس كثيرين، وكيف لم تقم بتنبيه الرئيس لما كان يحدث من فساد وما تردده الأفواه من انتقادات، وإذا حدث أنها نبهته ولم يتجاوب فهل كان من الوطنية أن توضع الملفات في أدراج مغلقة تلقى مفاتيحها في غيابات جُبٍّ لا يمرّ به بعضُ سيّارة.
وحدث الانفجار الشعبي، وسقط المسؤول الأول في الدولة، وتزايدت الصيحات بضرورة مواصلة التطهير، ومع تتابع جمعات الحراك أصبحت المطالبة بتنحي فلان أو فلتان محطّ تساؤلات كثيرة، بعد أن بدا أن بعض من يجعلون من هذه القضية مبررا للزعبطة والمزايدة والابتزاز يعملون طبقا لأجنداتٍ من بين أهدافها انتزاع التموقع في قمة السلطة القيادية، عبر ابتزاز المؤسسة العسكرية، ودعوتها بدون جدوى للتدخل.
وبدأ كثيرون يتصورون أن انتخاب رئيس جديد، وهو ما يجب أن يتم في نحو شهرين على أكثر تقدير، سيمكن البلاد من التركيز على اقتلاع الفساد الذي ينادي الجميع بمحاربته، وحيث بعض الفاسدين هم الأضخم أصواتا، ومن هنا تزايد الشعور بأن كل عرقلة لإنجاز ما تحدده مواد الدستور من خطوات في إطار الشرعية قد يؤدي بنا إلى وضعية من الفوضى الإدارية والسياسية، سوف تمكن كبار الفاسدين لا من إجهاض عملية المحاسبة فحسب، بل وربما مطاردة كل من طالب بالقضاء على الفساد، وهذا واحد من خلفيات العمل المحموم لعرقلة المسيرة نحو التطبيع التام للحياة السياسية.
وبموازاة ذلك تتكرر حكاية الثور الأبيض، وقد تثبت الأيام أن بعض من ينادون برحيل الباءات الثلاثة أو اٍلأربعة يُخفون قوائم أخرى تستهدف التخلص من إطارات في مستويات معينة، لأن وجودها في المسؤولية يعرقل أطماع العاملين لسرقة السلطة تحت أسماء متعددة، كهيئة رئاسية أو مجلس حكماء أو رئاسة شرفية وما إلى ذلك.
وهكذا تناقلت الأخبار في تيزي وزو، إحدى الولايات الـ48، أن بعض أصحاب الجبة السوداء ( أي المحامين، وجلهم من اتجاه واحد) جابوا شوارع المدينة، مرددين شعارات “لا فنيش لا بن صالح، والنظام رايح رايح”( وهكذا أضيفت فاءٌ للباءات)
ومن نفس المنطقة انطلق خبير دستوري، كان ممن يطالبون بالقرءاة “السياسية” لنصوص الدستور، راح يكرر قضية العيب الشكلي (vice de forme) والذي كان استعمله، في التعليق على موقف رئيس أركان الجيش، “ناشط” كبير يحاول كثيرون تلميعه، وطردته جماهير أكثر من تجمع.
وخبيرنا اليوم يقول إن في تعيين رئيس المجلس الدستوري الجديد خرق للمادة 183 من الدستور، زاعما وجود عيب في الشكل (والشكل هنا هو أن المادة تنصّ على أن “رئيس الجمهورية” هو من يُعيّن رئيس المجلس الدستوري وليس “رئيس الدولة”، في حين أن المادة (104) لا تجعل من تعيين رئيس المجلس الدستوري حقا ممنوعا على رئيس الدولة.
وربما كان من خلفية الخبير خشيته، ومن وراءه، من احتمال تعيين فنيش كرئيس للدولة في حالة استقالة بن صالح، وتضيع الفرصة على “الناشط الكبير” والبرلماني الحزبي القديم.
ويتأكد أن الأمر هو أكثر خطورة، وهو ما كشف وضعية الصراعات الخفية التي تمثل الجزء المغمور من جبل الثلج العائم، ولخصه محمد يعقوبي بالأمس في “الفيس بوك” حيث يقول:
“نحن أمام دولتين عميقتين متحالفتين، على ما بينهما من عداء، الأولى عمرها 25 سنة (مدير الأمن السابق الذي أشار له رئيس أركان المؤسسة العسكرية بالأمس مُحذرا إياهُ ومن معه) والثانية عمرها 20 سنة (القوى غير الدستورية التي كان علي بن فليس أول من ندد بها علانية) هاتان الدولتان تشكلان حاليا تحالفا شرسا ضد قيادة الجيش، تم توقيع عقده في الاجتماع السري المشبوه الذي فضحته قيادة الأركان يوم 30 مارس الماضي، والهدف من هذا الحلف بين تكتلين تشابكت مصالحهما، هو الوقوف في وجه المتابعات القضائية التي أمرت بها قيادة الأركان والتي ينتظر أن تطال المئات من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين، فضلا عن ثمانية بارونات نهبوا ما لا يقل عن 10 مليار دولار كقروض من الأموال التي طبعها أويحيى خصيصا لهم خلال العامين الماضيين.
هدف هذا الحلف الخطير هو كبح فتح ملفات الفساد، وإطالة عمر المرحلة الانتقالية وإجهاض أي حل دستوري يعيدنا الى المسار الانتخابي، وإدخال البلاد في الفراغ والفوضى، ووضع الجيش وقيادته وجها لوجه مع الحراك الشعبي، وبالتالي الدخول في الحالة الاستثنائية التي يرفضها الجيش إلى الآن”.
ويواصل مدير صحيفة الحوار قائلا: “لا يوجد أي جيش في العالم تتوفر لديه ظروف إعلان حالة الطوارىء ثم يرفض إعلانها ويصر على الحلول الدستورية والعودة سريعا إلى المسار الانتخابي إلا إذا كان جيشا شعبيا وطنيا حريصا على بلاده.
صحيح هناك ضبابية في الرؤية والتصور للحل وقصور في التعاطي مع حالة الوعي التي صنعها الشارع، لكن حرص قيادة الجيش يبدو كبيرا جدا على التمسك بالدستور الذي يجنب البلاد الفوضى، وعلى حماية أموال الشعب من التهريب واسترجاع القروض المنهوبة من الأموال المطبوعة عنوة وإجراما.”
هذه الصورة لن تكتمل إلا إذا أضفنا ما نشر مؤخرا في موقع “البلاد” من أن حالة من الحنق والغضب تسود السلطات الفرنسية من موقف الفريق قايد صالح قائد الأركان، الذي تعتبره مسؤولا عن تصاعد عدم الترحيب بالدور الفرنسي في الجزائر، وخصوصا فيما يتعلق بصفقات الأسلحة، حيث أصبحت الجزائر تتجه أكثر إلى روسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بل إن عنوان وزارة الدفاع الجزائري في أعالي حيّ “الثغوريين” بالعاصمة الجزائرية مكتوب بالعربية وبالإنغليزية، وهو ما أظن أنه يعود لعهد الجنرال مصطفى بللوصيف.
ولقد بدأ في التبلور يقين عام بأن القضاء على الفاسدين الكبار أمر بالغ السهولة إذا تحقق الاستقرار ولو نسبيا، وعند قطع الرأس يصبح قطع الذنب تحصيل حاصل، وهنا نفهم سر الضجيج والتشنج ونقل الجموع من بعض ولايات الوطن إلى وسط العاصمة، حيث تتكاثر كاميرات التلفزة.
وأذكر ثانية بأن اليقين العام هو أن كبار الفاسدين ممن يعملون بدون هوادة لإفشال الانتقال السلس للسلطة كانوا ممن اقترضوا، بفضل وساطات مشبوهة، أموالا هائلة لم يسددوا معظمها بعد، ونقلوا بعضها أو حجما منها إلى فرنسا وربما إلى جزر البهاما، أو ممن زوروا حساباتهم لعدم دفع الحجم المطلوب من الضرائب المقررة، أو ممن يوزعون الرشاوى المباشرة وغير المباشرة على “النخبة” التي تدعم مشروعهم التخريبي، من سياسيين وإعلاميين وجامعيين، وهم من يستوردون اللافتات الضخمة والإعلام الفئوية التي تستهدف إعطاء انطباعات مزيفة عن توجهات المتظاهرين، وهم الذين دفعوا ببعض الملتحين إلى شوارع العاصمة منادين بالشعارات التي كانت وراء الأزمة في التسعينيات.
ومعظم أولئك ممن يرتبطون بعلاقات مالية وتجارية، وربما سياسية وفكرية ومخابراتية، مع الجانب الآخر من المتوسط.
وهنا يتضح معنى الإشارة للأيادي الخارجية.
*مفكر وكاتب ووزير اعلام جزائري سابق
نقلاً عن رأي اليوم